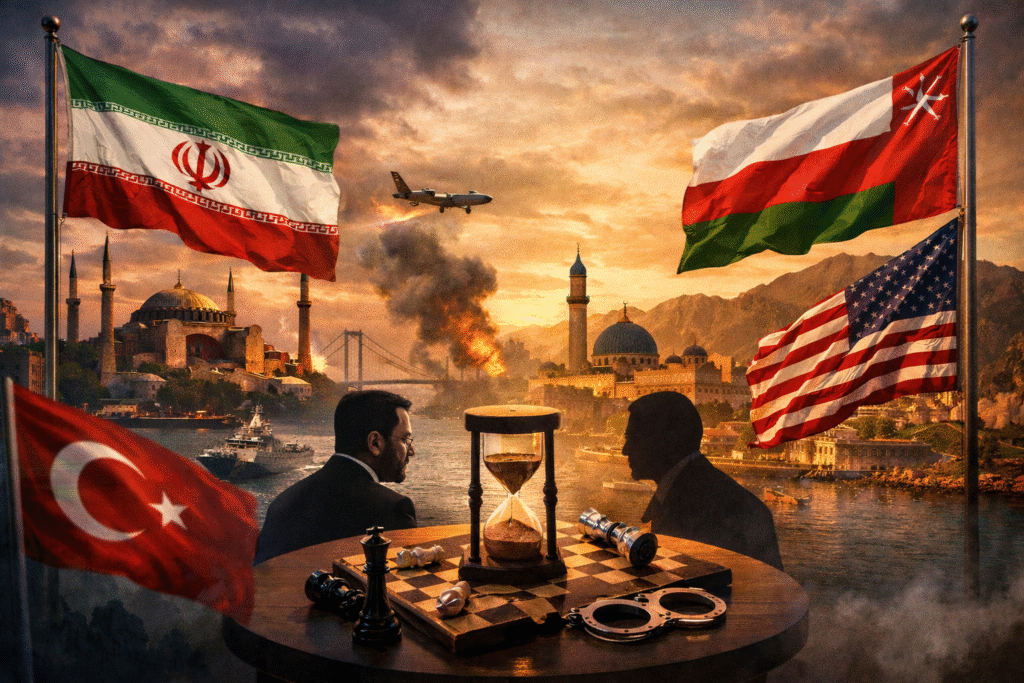ترامب بين ضغوط نتنياهو وحسابات الداخل الأميركي

ترامب بين ضغوط نتنياهو وحسابات الداخل الأميركي
علي منصور – ليبانغيت
ليست إيران وحدها على طاولة القرار في البيت الأبيض، بل مستقبل دونالد ترامب السياسي والرئاسة الأميركية نفسها. فالأزمة تتجاوز حدود البرنامج النووي الإيراني لتلامس جوهر الدور الأميركي في الشرق الأوسط، وحدود القوة وكلفة استخدامها. وبين ضغط إسرائيلي يدفع باتجاه تحويل التصعيد القائم إلى حرب مفتوحة، وتصعيد أميركي يدرك مخاطر الانفلات، يقف ترامب أمام مفترق حاسم سيحدّد مسار رئاسته سياسيًا.
هل يختار أن يكون قائدًا يضع حدًا لمحاولات استدراج الولايات المتحدة إلى حروب الآخرين، أم رئيسًا يسمح بتوريط أميركا في صراع إقليمي لا تملك مفاتيح نهايته، ولا تتحكم بتداعياته السياسية والاقتصادية والانتخابية؟
في هذا الهامش الضيّق بين الردع والحرب، وبين الضغط والتسوية، تُصاغ قرارات لا ترسم مصير العلاقة مع إيران فحسب، بل تعيد تعريف معنى القيادة الأميركية في مرحلة لم تعد تحتمل مغامرات كبرى ولا رهانات خاطئة.
إعادة جدولة محادثات مسقط لم تكن تفصيلًا، بل نتيجة مباشرة لشروط فرضتها إيران على مسار التفاوض. غير أن قبول واشنطن بهذا التبديل عكس معادلة أميركية مزدوجة: إدارة تلوّح بالقوة وتواصل التصعيد الميداني، لكنها في الوقت نفسه تدرك أن كلفة الانزلاق إلى حرب شاملة — انتخابيًا واقتصاديًا — تفرض عليها سقفًا لا تستطيع تجاوزه. ومن داخل هذا التوازن، تحاول إسرائيل دفع واشنطن إلى تخطّي هذا السقف وجرّها نحو مواجهة مفتوحة مع طهران.
على مدى حياته السياسية، قدّم بنيامين نتنياهو إيران بوصفها التهديد الوجودي الأول لإسرائيل، مستخدمًا هذا التصوير لتبرير تعطيل الاتفاقات الدولية، وتوسيع دوائر الاشتباك، والإبقاء على المنطقة في حالة توتر دائم. غير أن التحول الأهم اليوم لا يكمن في حدّة الخطاب، بل في طبيعة الاستراتيجية: إسرائيل لم تعد تجرؤ على خوض مواجهة مباشرة مع إيران، وتريد من الولايات المتحدة أن تقوم عنها بالمهمة وتتحمّل أكلافها.
في هذا السياق، يتحرك نتنياهو لدفع ترامب من سياسة «الضغط المحسوب» إلى حافة الحرب المفتوحة، مستندًا إلى نفوذه السياسي وقدرته على التأثير في القرار الأميركي. الهدف ليس فقط منع أي تسوية مع طهران، بل جرّ القوة الأميركية إلى صراع إقليمي تتولى إسرائيل توجيهه سياسيًا، فيما تتحمل واشنطن أعباءه العسكرية والاقتصادية.
الخطاب الإسرائيلي يرفض أي اتفاق نووي لا يشمل البرنامج الصاروخي الإيراني ونفوذ إيران الإقليمي، رغم أن هذه الشروط لم تكن يومًا جزءًا من الاتفاقات النووية في أي مكان في العالم. واللافت أن إسرائيل، الدولة النووية غير الخاضعة لأي رقابة دولية، تطالب بتجريد خصومها من كل أدوات الردع، ثم تقدّم ذلك بوصفه دفاعًا عن «الأمن الإقليمي».
يتعامل نتنياهو مع الحرب على أنها مشروع يمكن خصخصته: حرب تُخاض باسم الأمن القومي الإسرائيلي، لكن بأدوات أميركية، وبتكلفة يتحمّلها دافعو الضرائب الأميركيون وشعوب المنطقة.
واشنطن بين التهديد والحساب البارد
رغم لغة التهديد التي يستخدمها ترامب، ورغم تحذيراته العلنية للقيادة الإيرانية، فإن سلوك الإدارة الأميركية يكشف تردّدًا حذراً . فواشنطن وافقت على العودة إلى طاولة التفاوض في مسقط بعد ضغوط إقليمية واضحة، خصوصًا من دول عربية وإسلامية تدرك أن أي انفجار لن يكون قابلًا للاحتواء.
تطالب الولايات المتحدة بتوسيع المفاوضات لتشمل ملفات غير نووية، تلبيةً للشروط الإسرائيلية، بينما تتمسّك إيران بموقف واضح: النووي مقابل العقوبات، لا أكثر ولا أقل. ولا يعكس هذا الإصرار الإيراني تعنّتًا بقدر ما يعكس قراءة دقيقة للتجربة السابقة، حيث تحوّلت الاتفاقات الموسَّعة إلى أدوات ابتزاز لا إلى ضمانات استقرار.
من يدفع الثمن ليس إسرائيل
في المقابل، تعبّر دول المنطقة عن مخاوف عميقة من أي مغامرة عسكرية ضد إيران، انطلاقًا من إدراكها أنها ستكون في طليعة من يدفع الثمن. هذه الدول لا تملك القدرة على فرض إرادتها على واشنطن، لكنها تحاول التأثير في القرار الأميركي عبر التحذير والضغط السياسي، رافضة استخدام أراضيها أو أجوائها لأي ضربة محتملة.
صحيح أن إيران أعلنت بوضوح أنها ستردّ على أي هجوم باستهداف إسرائيل مباشرة، إلا أن ذلك لا يبدّد هواجس دول المنطقة، بل يضاعفها. فحرب من هذا النوع لن تبقى محصورة بين الجمهورية الإسلامية والكيان المحتل، بل ستتمدّد سريعًا إلى ساحات الطاقة والملاحة والقواعد الأميركية، ما يعني تعطيل المنشآت النفطية والحيوية، وإغلاق مضيق هرمز، وإطلاق موجة اضطراب اقتصادي وأمني لن تنجو منها أي عاصمة في المنطقة.
في هذا المشهد، قد تكون إسرائيل هدفًا مباشرًا للرد الإيراني، لكنها ليست بالضرورة الطرف الذي سيدفع الكلفة الأوسع والأطول أمدًا، فيما تتحمّل دول الإقليم والاقتصاد العالمي العبء الأكبر لانفجار لا تملك أدوات التحكم به.
كلفة الحرب خارج الميدان
اقتصاديًا، تبدو واشنطن في موقع لا يحتمل حربًا جديدة. فارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية سيعيد التضخم بقوة إلى الداخل الأميركي، في لحظة سياسية شديدة الحساسية. ومع اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر 2026، قد تتحول أي صدمة اقتصادية إضافية إلى عبء انتخابي ثقيل، يهدد الأغلبية الجمهورية ويفتح الباب أمام خسائر سياسية واسعة.
الأهم أن المزاج الشعبي الأميركي تغيّر. حتى قاعدة ترامب الصلبة لم تعد ترى في الحروب الخارجية تعبيرًا عن «القوة»، بل عن استنزاف بلا طائل. خسارة الكونغرس لا تعني فقط تعطيل أجندة ترامب، بل فتح الباب أمام تحقيقات ولجان واستنزاف سياسي طويل.
ما بعد 2026: الترامبية تحت الحصار
الخطر الحقيقي على ترامب لا يكمن في إيران، بل في الداخل الأميركي. خسارة الانتخابات النصفية ستجعل من رئاسته رئاسة محاصَرة، وتفتح المجال أمام إعادة فتح ملفات حساسة، من بينها قضايا لم تُغلق تمامًا، مثل ملف جيفري إبستين، وغيره من القضايا التي يمكن توظيفها سياسيًا.
هنا، لا يصبح الهدف إسقاط قرار أو تعطيل سياسة، بل تفكيك «الترامبية» كمشروع حاكم، وتحويل ترامب من قائد تيار شعبي وازن إلى عبء سياسي على حزبه، بما يمنع نقل النفوذ إلى أي مرشح محسوب عليه في انتخابات الرئاسة عام 2028.
حرب إسرائيل… واختبار الرئاسة الأميركية
في المحصلة، لا يقف دونالد ترامب أمام خيار تكتيكي بين تصعيد وتهدئة، بل أمام قرار استراتيجي يمسّ جوهر الدور الأميركي نفسه. فالحرب مع إيران، إن وقعت، لن تكون تعبيرًا عن قوة أميركية بقدر ما ستكون استجابة لضغوط إسرائيلية، بكلفة تتحمّلها واشنطن اقتصاديًا وسياسيًا، وتُدفَع المنطقة أثمانًا طويلة الأمد.
إيران، مهما اختلفت التقديرات حول سياساتها، تُظهر سعيًا واضحًا إلى اتفاق يخفف عنها العقوبات ويحفظ لها هامش السيادة، لا إلى مواجهة شاملة تفتح كل الجبهات. في المقابل، فإن إسرائيل هي الأكثر اندفاعًا نحو خيار الحرب، لكن من موقع من لا يرغب في خوضها منفردًا، بل في إدارتها من الخلف وبتكلفة موزّعة على الآخرين.
سيجد ترامب نفسه بين هذين المسارين: إما تثبيت سقفٍ للتصعيد يمنع توريط الولايات المتحدة في حرب لا تخدم مصالحها، أو القبول بانزلاقٍ تدريجي نحو مواجهة إقليمية لا تملك واشنطن وحدها مفاتيحها ولا تتحكم بمآلاتها.