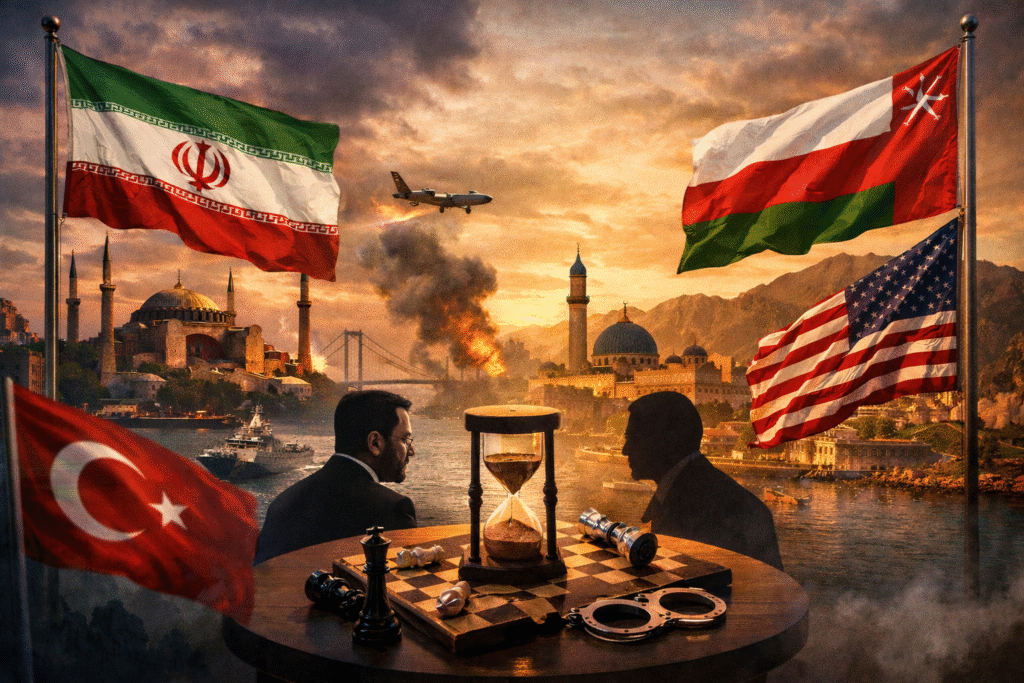جيفري إبستين: مرآة مكسورة لوجه النظام القبيح

جيفري إبستين: مرآة مكسورة لوجه النظام القبيح
علي منصور – ليبانغيت
قضية جيفري إبستين ليست مجرد شبكة استغلال جنسي للقاصرات، ولا فضيحة أخلاقية تخص أفرادًا منحرفين خرجوا عن القانون. إنها، في جوهرها، فضيحة نظامية كاملة، تكشف كيف يتحالف المال والنفوذ والسلطة لصناعة حصانة شبه مطلقة، وكيف يُدار الصمت الإعلامي والقضائي بوصفه أداة تغطية وحماية للمرتكبين .
اليوم، ومع إعلان وزارة العدل الأميركية في 30 كانون الثاني/يناير 2026 عن نشر أكثر من ثلاثة ملايين صفحة إضافية من وثائق القضية – تتضمن نحو ألفي فيديو ومئة وثمانين ألف صورة – يتضح أن ما جرى ليس «انتصارًا للشفافية»، بل عرضًا مدروسًا لتشويهها.
نشرٌ متأخر أسابيع عن الموعد القانوني، أخطاء فادحة أدت إلى كشف هويات عشرات الضحايا، ثم سحب آلاف الوثائق تحت ضغط محامي الضحايا الذين وصفوا العملية بأنها «إهمال جنائي وتستر نشط».
دولة تعلم… ثم تتظاهر بالدهشة
وزارة العدل، تحت إدارة دونالد ترامب، تتباهى بـ«الامتثال الكامل» لقانون «شفافية ملفات إبستين» الذي وقّعه الرئيس نفسه في تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
لكن الوقائع تقول شيئًا آخر:
أُفرج عن نحو نصف الملفات فقط من أصل ستة ملايين صفحة محتملة، فيما جرى احتجاز البقية بذريعة «حماية الضحايا» أو «محتوى إباحي للأطفال»، في مفارقة فاضحة، إذ فشلت الوزارة نفسها في حماية الضحايا عند النشر!
ثم تصل الوقاحة إلى ذروتها حين يعلن نائب المدعي العام أن المراجعة انتهت، وأنه «من غير المحتمل» توجيه أي اتهامات جديدة.
الدولة التي كانت تعلم بإساءات إبستين منذ عام 2008، وسمحت له حينها بالإفلات بعقوبة شبه رمزية، تعود اليوم لتغلق الدائرة ذاتها:
معرفة مسبقة، إفلات، ثم مسرحية كشف متأخر بلا محاسبة.
هذا ليس فشلًا إداريًا.
هذا سلوك دولة تحمي نخبها.
الإعلام الأميركي : تواطؤ قذر
أمّا الإعلام الأميركي السائد، من «فوكس نيوز» إلى «سي إن إن» و«أي بي سي» وغيرها من القنوات، فلم يكن ضحيةَ التضليل، بل شريكًا فيه. فعلى مدى سنوات ، تجاهل الإعلام الروابط العميقة بين إبستين وكبار السياسيين والمليارديرات، من ترامب إلى كلينتون، ومن غيتس إلى ماسك وغيرهم. واليوم، يتعامل مع نشر الوثائق كما لو أنه «اكتشافٌ مذهل»، فيما يتجنّب السؤالَ المركزي:
لماذا صمتم ثمانية عشر عامًا؟
لأن الإعلام نفسه مملوك أو مرتهن للبنية المتهمة ذاتها التي يحميها وتحميه .
شبكات كبرى تتظاهر بالحياد، لكنها تدفن الحقيقة تحت طبقات من التفاصيل السطحية، وتستبدل التحقيق الجذري بسجالات شكلية.
هذه ليست صحافة، بل إدارة وعي لحماية النظام.
النخب السياسية: الوحوش خلف الواجهة
السياسيون هم الحلقة الأوضح في هذه المنظومة.
ترامب يدّعي أن الوثائق «تبرئه»، رغم ورود اسمه مئات المرات في سياقات مريبة، ورغم أن إدارته أُجبرت على هذا «الكشف» المشوّه.
وكلينتون، وغيتس، وغيرهم، تربطهم علاقات بإبستين حتى بعد إدانته الأولى، ومع ذلك يتمتعون بحصانة كاملة . فلا محاكمات، ولا عقوبات، ولا حتى مساءلة.
هؤلاء ليسوا «معارف سابقين» لجيفري إبستين، إنما هم جزء من شبكة محمية بالقانون الذي تصوغه، وبالإعلام الذي يخدمها، وبالمال الذي يشتري الصمت.
سكوتهم ليس ارتباكًا، بل ثقة بالنظام.
والنظام، بدوره، يتصرف على هذا الأساس.
الشعب كمتلقٍ للفتات
ما يُقدَّم للرأي العام الأميركي اليوم ليس الحقيقة، بل فتاتًا محسوبًا من الوثائق، كافيًا لإيهام الناس بأن شيئًا كُشف، وغير كافٍ لإسقاط أحد.
أما المتورطون الحقيقيون، فيبقون في الظل، يراقبون المشهد بهدوء.
هكذا يُدار الغضب.
وهكذا تُفرَّغ العدالة من معناها.
جيفري إبستين مات داخل سجن فدرالي في نيويورك عام 2019، في واقعة أعلنت السلطات الأميركية رسميًا أنها نتيجة انتحاره شنقًا. غير أن الملابسات التي أحاطت بالواقعة أبقت الرواية الرسمية موضع تشكيك واسع، إذ تزامن تعطّل كاميرات المراقبة في محيط زنزانته مع غياب الحراس عن أداء مهامهم ونومهم خلال الفترة الحرجة، إضافة إلى تسجيل كسور خطيرة في عظام الرقبة وفق تقارير طبية أثارت جدلًا بين خبراء الطب الشرعي. عند هذه النقطة، يصبح السؤال مشروعًا سياسيًا وأخلاقيًا : كيف يمكن لرواية انتحار أن تصمد، فيما تعطّلت الكاميرات، وغاب الحراس عن المراقبة، وسُجّلت كسور خطيرة في الرقبة في اللحظة نفسها؟
غياب إبستين، سواء أكان انتحارًا أم قتلاً ، أدّى عمليًا إلى إقفال الملف لسبع سنوات كاملة مرّت قبل أن يُعاد تحريك القضية، لا بدافع العدالة، بل تحت ضغط ظروف سياسية فرضت إعادة فتحها.
وحين فُتح الملف أخيرًا، لم يُفتح على مصراعيه، بل أُعيدت هندسته: كشفٌ انتقائي للوثائق، توقيت محسوب، وحدود واضحة لما يُسمح بمعرفته وما يجب أن يبقى مطموسًا. لم يكن الهدف مساءلة المتورطين، بل إدارة الضرر، واحتواء الغضب، ثم إقفال القضية بصيغة «نهائية» لا تُنتج محاسبة ولا تترك بابًا مفتوحًا.
بهذا المعنى، لم تُستخدم الوثائق لإحقاق العدالة، بل لتعطيلها.
ولم يُستدعَ ملف إبستين لكشف الحقيقة، بل لضمان ألّا تُستكمل.
ومع إعلان وزارة العدل أن هذا هو «الإصدار النهائي»، رغم احتجاز ملايين الصفحات الأخرى، ورغم الأذى الذي لحق بضحايا جدد، يصبح السؤال أكثر إلحاحًا:
كم ملفًا شبيهًا بإبستين ما زال مدفونًا في خزائن الدولة، بانتظار لحظة ابتزاز سياسي أو صفقة خفية؟
إن لم يُحاسَب هؤلاء الآن، فلن ينتج النظام «إبستين آخر» فحسب، بل سيستمر في إنتاج أجيال من الضحايا، محميًا بالصمت الإجرامي للدولة والإعلام والنخب.
ما جرى في ملف إبستين لا يثبت أن النظام فاسد فحسب، بل يكشف قدرته الهائلة على امتصاص الفضائح من دون أن يتصدّع. فهو لا يكتفي بمنع الحقيقة، بل يعيد صياغتها وفقاً لمصالح النخب ، ويقدّم للرأي العام ما يكفي لاحتواء الغضب، لا لمساءلة فعلية.
بهذا المعنى، لم يكن نشر الوثائق خطوة نحو العدالة، بل إدارة محسوبة لأزمة كادت أن تخرج عن السيطرة. وحين تُدار الفضائح بهذه الطريقة، لا تعود المشكلة محصورة في أفراد تورّطوا، بل في نظامٍ يعرف كيف يحمي نفسه، حتى وهو يسمح بكشفٍ محدود لعوراته.