من يحتكر استيراد المحروقات في لبنان؟
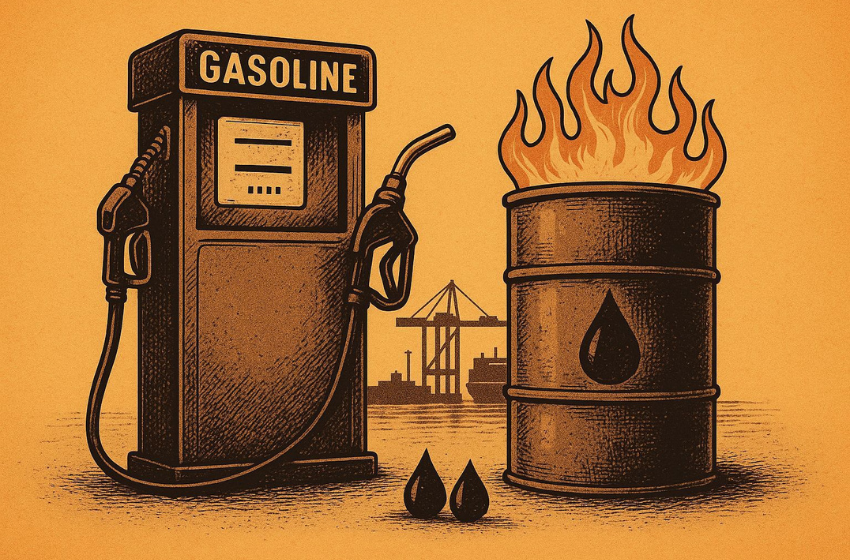
زينة برجاوي – ليبانون غيت
في بلدٍ يتقلّب فيه سعر البنزين كما تتقلّب نشرات الطقس، لم يعد استهلاك المحروقات مسألةً اقتصاديةً فحسب، بل بات قصّةَ احتكارٍ مزمنٍ لا يخفى على أحد. فالبنزين والمازوت والغاز ليست مجرّد موادّ تُستورد وتُباع، بل أوراق ضغطٍ تمسك بها قلّة من الشركات النافذة، وتُدار بمنطق السوق المغلقة لا بمنطق المنافسة.
لسنواتٍ طويلة، ظلّت عمليات استيراد المحروقات محصورة بعددٍ محدودٍ من الشركات، تتكرّر أسماؤها على الفواتير ومحطّات التعبئة، من IPT وCoral إلى Medco وTotal وغيرها. لم تكن هذه الشركات مجرّد كياناتٍ تجارية، بل أذرعًا غير مباشرة لمرجعياتٍ سياسية ومالية، نسجت علاقاتٍ طويلة مع الوزارات والإدارات، وكرّست لنفسها دورًا حصريًا في التحكّم بالسوق.
في زمن الدعم، كانت الكارثة مضاعفة؛ فبينما كان مصرف لبنان يدفع مليارات الدولارات لتأمين المحروقات بأسعارٍ مدعومة، كانت الكميات تُهرَّب إلى سوريا، وتُخزَّن في مستودعاتٍ خاصة بانتظار رفع الدعم لتحقيق أرباحٍ خيالية. المواطنون اصطفّوا في طوابير الذلّ، بينما راكم بعض المستوردين الثروات. كانت الأزمة تُقدَّم على أنّها نقصٌ في التوريد، لكنّ الحقيقة كانت اختناقًا مصطنعًا لرفع الأسعار لاحقًا.
وعندما قرّرت الدولة رفع الدعم في عام 2022، ظنّ البعض أنّ السوق سيتحرّر وأنّ الأسعار ستُضبط، لكنّ الواقع أثبت العكس. صحيحٌ أنّ الجدول اليومي للأسعار بات يصدر عن وزارة الطاقة، لكنّه يُعدّ عمليًا بالتشاور مع الشركات نفسها، التي ظلّت اللاعب الأقوى في تحديد هوامش الربح والكميات والتوزيع.
المشكلة لم تكن يومًا في سعر النفط العالمي، بل في غياب الدولة عن إدارة ملفٍّ استراتيجي بهذا الحجم. فلا منشآت حكومية تملكها الدولة للاستيراد، ولا رقابة فعّالة على المخزون أو الاحتكار، ولا نظام شفاف لتوزيع الحصص أو مراقبة التخزين. حتى منشآت النفط الرسمية، كطرابلس والزهراني، تُدار بالمحاصصة، وتُعطَّل أحيانًا بقراراتٍ سياسية.
في هذا الواقع، لم تعد المحروقات مجرّد حاجةٍ يومية، بل عبئًا اجتماعيًا تتحكّم به الكارتيلات كما تشاء. بات المواطن يحسب تنكة البنزين قبل كل مشوار، ويُدرج سعر الغاز ضمن لائحة نفقاته الشهرية بدقة. أمّا الدولة، فإمّا عاجزة… أو متواطئة.
في النهاية، لم تعد النار التي تشتعل في المحرّكات هي الخطر الحقيقي، بل النار التي تشتعل في الجيوب.
وكلّما ارتفع السعر، تكرّر السؤال نفسه:
هل نحن ندفع ثمن النفط… أم ثمن الصمت؟


